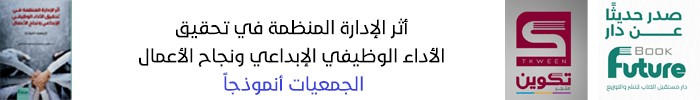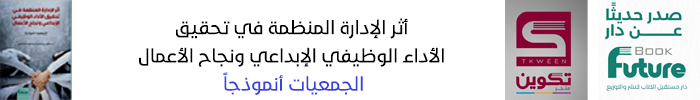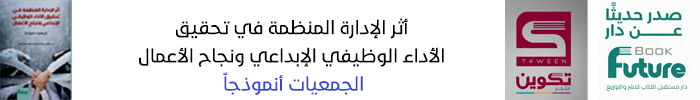ضمن سلسلة اللقاءات المقدمة من معهد أكاديميون عبر منصة أكاديميون الثقافية، المنصة الغير ربحية التي تهتم بنشر المعرفة والعلوم من خلال سفراء ومستشاري المعهد، وعبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية، قدمت المنصة اللقاء الأسبوعي يوم الثلاثاء الموافق 23/1/1443هـ التي تم فيها استضافة سعادة الدكتور: وليد بن بليهش العمري، أستاذ دراسات الترجمة المشارك بجامعة طيبة وعضو مركز الترجمات بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعضو المجلس العلمي بوقف تعظيم الوحيين، وعضو الهيئة الاستشارية للموسوعة المتكاملة للقرآن الكريم الصادرة عن مركز الإسلام والعلم بكندا، وقام بتقديم اللقاء الدكتور مشعل المحلاوي، وقد بدأ اللقاء عند الساعة العاشرة مساءً عبر برنامج ((ZOOM.
بدأ الدكتور العمري الأمسية بحديثه عن القول "شيء عن كل شيء" وأنه يعني التعاطي مع الأسئلة المهجورة، والقضايا التكوينية عن ترجمة معاني القرآن الكريم، والأسئلة تكون حول جواز ترجمة القرآن والجدل الذي دار حوله، وأنه قد اجيز في البداية على مضض وقيد ثم بعد ذلك فتح الباب على مصراعيه ورؤي أنه عمل حيوي ومهم، وأن هناك مسلمة في استحالة ترجمة القرآن الكريم، مع أن هذه الترجمة تحدث بشكل يومي وأمر شائع ولا مناص منه، وأن هناك ثنائية الحرفية والمعنوية حيث حللوا المعنوية وحرموا الحرفية بناء على أفكار مغلوطة عن طبيعة اللغات والترجمة، كما أن هناك علاقة بين الترجمة والتفسير فهما أمران شديدا التداخل وشديدا التباين، وأن هناك أيضًا قضية نقد ترجمات القرآن الكريم وما يعتلي هذا النقد، وأن هناك المختصرات التفسيرية التي تظهر لنا بين الفنية والفينة والتي يراد منها إبدال الترجمات بها وينم عن عدم الوعي بأهمية الترجمة ودينامية اللغات، واختلاف عملية الفهم والتأويل، وهناك منظور على أن الترجمة مجرد نقل فظلموها وهمشوها وأوكلوها لكل من يتولى وزرها، كل ذلك أدى إلى تأخر النظرية عن التطبيق.
ووضح الدكتور العمري أن قضية ترجمة القرآن الكريم تنبع أهميتها من أنه كتاب الإسلام الأول، ودستوره وخازن هوية المسلمين وعليه قد كثر طالبي ترجمته على اختلاف مشاربهم على امتداد الدهور والأزمان، وكان منهم من أخلص النية لله تعالى ومنهم من هو دون ذلك، وأن حركة الترجمة تختزل في جنباتها مجمل تاريخ علاقة الإسلام بالشعوب من خلال سيرتهم التاريخية وما مروا به من حوادث وما عرضت لهم من عوارض.
واستعرض الدكتور العمري أبرز محطات ترجمة القرآن الكريم حيث مرت بخمس محطات، فكانت المحطة الأولى: بترجمة القرآن إلى عدد كبير من اللغات الأوروبية خوفًا من الجيوش العثمانية الإسلامية التي كانت تهدد وجود أوروبا وينذر بمحو هويتهم، وهدفت تلك الترجمات إلى تعزيز الدفاعات الداخلية وتحصين المواطنين الأوروبيين ضد الانهزام النفسي، والتأثر برسالة الإسلام، وعمدت تلك الترجمات إلى تشويه الإسلام، وذلك ظهر حتى من عناوين تلك الترجمات ومن البيانات التمهيدية التي ألحقت بها.
والمحطة الثانية: كانت في شبه القارة الهندية التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار البريطاني وجاءت تلك الترجمات كردة فعل لتنفي عن الإسلام التهم التي كالها المستعمر ضده، فكانت حركة ممانعة ومقاومة عكسية لتفنيد آراء المستشرقين أمثال: (د- سيل، وبالمر والسير، وليام موير)، فالتقى في تلك المحطة الشرق بالغرب ليشكل أرض صراع ومشاحنة، وكان الإسلام والقرآن في لُبها، ويؤخذ على ترجمات تلك الحقبة عدم إتقان صنعة الترجمة من باب، وضعف اللغة التي كتبت بها من باب آخر.
والمحطة الثالثة: كانت في الرغبة الصادقة لإخراج ترجمة توضح معنى القرآن الكريم الحقيقي، وكانت من أكثر الترجمات الإنجليزية شيوعًا وانتشارًا، فصدرت ترجمة (بكثول) في 254 طبعة، وترجمة عبدالله يوسف على 265 طبعة، وقد قامت المستشرقة الشهيرة (جسن مكاوليف) بإصار نسخة محدثة من ترجمة بكثول عام 2017م، وقامت دار الإفتاء السعودية بمراجعة ترجمة يوسف علي فأزالت ما علق بالترجمة من الشوائب وحذفت كثيرًا من الحواشي، ولكن هذه الطبعة كان فيه دَخَن ولذا تم الاستغناء عنها.
والمحطة الرابعة: تعدد المدارس وإدلاء كل بدلوه، رغبة في جعل القرآن يقول ما يريدون، وتأييدًا لموقفهم في الحياة وبخاصة مع تشكل الجاليات والأقليات المسلمة واستيطانهم الغرب، وأخذت الترجمات في الصدور من جميع أنحاء العالم، وتلك الحقبة تمخضت عن وجود ترجمة تعد من أشهر الترجمات الإنجليزية وأكثرها ذيوعًا وخرجت عن النطاق الديني البحث إلى إنزال الواقع على الترجمة وهي ترجمة: محمد أسد 1980م ذات النبرة الاعتذارية والتي اتسمت بالعقلانية والعصرانية.
المحطة الخامسة: وهي تعد من أهم المحطات وأكثرها كثافة وهي الفترة التي جاءت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أي خلال السبعة عشرة سنة الماضية، وقد صدرت فيها 54 ترجمة جديدة، وهو ما يمثل قرابة نصف عدد الترجمات صدرت في أقل من 5% من مدة تاريخ ترجمة القرآن إلى الإنجليزية الممتد منذ عام 1649، ويرجع السبب إلى الانقسام الشديد الذي شهده العالم في إثر هذه الهجمات المروعة مما حتم تحديد المواقف بكل وضوح، ودون مواربة وبخاصة في قضايا تتعلق بطبيعة العلاقة بين المسلم والآخر، وواقع المرأة في الإسلام ومدى تطبيق الحدود الشرعية والجهاد، وقد ظهرت عدة أصوات منها تلك التي تحررت كليًا من القيود والأصول التي كان يراعيها المترجمون في السابق.
وتطرق الدكتور العمري إلى ما آلت إليه الترجمة بعد 11 سبتمبر وإخفاق علماء المسلمين في وضع القرآن في سياقه التاريخي والمكاني إلى تعميمات ألحقت الضرر بالإسلام، وهذا الإخفاق يسهل استغلال القرآن من قبل حكومات تدعم التطرف ولا تفتأ أن تضرم نار الأحقاد والكراهية، كما يستغله الإرهابيون لكي يجعل نفسه مقبولاً في عالم يمزقه الإرهاب.
وأنهى الدكتور العمري حديثه عن الحاجة الماسة إلى التعاطي مع القضايا الحساسة في كل ثقافة، وبحاجة إلى عمل مؤسسي يحرر القول فيها وتقدم هذه الأقوال المحررة المعتبرة من علماء الإسلام للمترجمين لتضمينها في ترجماتهم، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتطوير آلية العمل في إعداد الترجمات، وحاجة كبيرة جدًا إلى إيجاد معينات للمترجم وأدلة إرشادية، كما أشار إلى أن المترجمون في الغالب هم ليسوا من أهل نظرية الترجمة ولم يدرسوها وربما لم يمارسوها من قبل وعدم وجود قاعدة تأسيسية تأصيلية في هذا الفن يؤدي إلى ضلل في بعض أعمالهم واضطراب المنهج أحيانًا، وعدم وضوح أدوار الفريق، وعدم وجود برامج حاسوبية معينة للمترجم، كما نحتاج إلى مؤتمرات تناقش الأسئلة، وجهات علمية في القضايا الحساسة، كل ذلك أدوات يجب أن تمنح للمترجم حتى تكون الترجمة في أوضح صورة للمتلقي.
وفي نهاية الأمسية شكر الدكتور مشعل المحلاوي الدكتور وليد بليهش العمري على ما قدمه من معلومات قيمة، كما شكر الحاضرين للأمسية على أمل اللقاء في يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم مع ضيف جديد على منصة أكاديميون الثقافية.